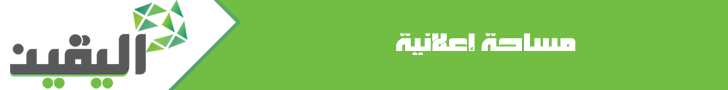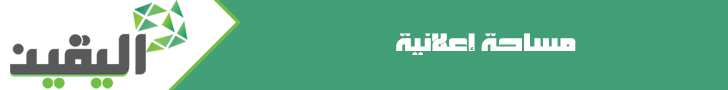الرياض تخرج من نفق الأزمة


انطوى الشق السياسي في جريمة مقتل المرحوم جمال خاشقجي، وسجَّل ولي العهد السعودي مهارة في إدارة الأزمة، فقطع -بإقراره بالطابع البشع للجريمة، وباستعداده محاسبة الفاعلين والتعاون إلى آخرالشوط لإجلاء الحقيقة ومحاسبة الفاعلين- الطريقَ أمام كل مَن كان يحاول استثمار الأزمة وقطف ثمارها سياسيًّا.
الأزمة أظهرت أن السعودية تمثل رقمًا صعبًا في المعادلة الدولية، وأنَّها قاطرة لعملية التنمية في المنطقة ككل، لا يمكن تجاوزها، وأن استسهال توجية الاتّهام والانتقاد لها، يمكن أن يكون مكلفًا من الناحيتين السياسية والمادية، حتى لو بدا للحظة أنه خيارٌ مغر لأولئك الذين يريدون تصفية الحسابات، أو يحسنون الاصطياد في الماء العكر.
ويبدو أن السعودية، بالرغم من الحملة النشطة التي تعرَّضت لها على مدى شهر كامل، خرجت من الأزمة أكثر صلابة، وأكثر قدرة على استئناف مسيرة التحديث والتطوير، لا من منظار وطني فقط بل على أساس إقليمي يضع الشرق الأوسط كله في الميزان.
السعودية في تعاطيها مع الأزمة تصرَّفت بمسؤولية الدولة الكبرى، وذلك بإعلان استعدادها لمحاسبة مَن ارتكب جريمة اغتيال خاشقجي، وتحمّلها المسؤولية الأدبية والقانونية عن هذه الجريمة.
ومع أن إعلان المملكة استعدادها لملاحقة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية عن التجاوزات، خلافًا للتفويض الممنوح لها وتجاوز القائمين عليها للصلاحيات المعطاة لهم، كان في جانب منه رسالة للخارج، إلا انه كان أيضًا رسالة للداخل السعودي، وهو في كل الأحوال خطوة لخلق بيئة عمل مطمئنة، لكل من يبحث عن فرص في برنامج التنمية الطموح الذي تنفذه المملكة.
في سباق المملكة للخروج من الأزمة، احتاجت الرياض إلى عمل دبلوماسي مكثف، لاحتواء آثار الجريمة في الداخل وعلاقاتها في الخارج. وقد نجحت الرياض في الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، عندما تراجعت بشجاعة عن موقفها الأوّل في التعاطي مع الجريمة. فمن حالة الإنكار التي كانت سمة غالبة على كل البيانات والتصريحات والتعليقات الأولى، ومن بيان غاضب في مصطلحاته ومدلولاته، أخذت المملكة خيار التراجع ومواجهة الحقائق، من خلال تسمية الأشياء بمسمياتها، وكذلك من خلال الإعلان عن اختيار العمل المشترك مع تركيا والمجتمع الدولي، لإجلاء الحقيقة وتحديد الفاعلين ومحاسبتهم.
لم تتورّع الرياض وهي تقوم بعملية المراجعة لمواقفها الأولى، أن تقر ابتداءً بالمسؤولية الجنائية لمواطنيها عن الجريمة، وبخطأ التوصيف الأوّل للجريمة وذيولها، وأن تتراجع عن محاولة تغطية التجاوزات التي ارتكبتها بعض الأجهزة لصلاحياتها ومسؤولياتها، وصولًا إلى استعدادها للتعاون في التحقيقات، وفي عقاب كل من يتأكد تورطهم في الجريمة.
بهذه المراجعة التقت المملكة في منتصف الطريق مع كل الجهات التي تريد تحقيقًا مهنيًّا، لا كيلَ الاتهامات السياسية. وبدا ذلك واضحًا في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يتضمَّن -بخلاف توقعات المتربصين- أيَّ اتهامات سياسية وهو يتناول جريمة اغتيال خاشقجي، وركز بدلًا من ذلك، على تفاصيل جنائية، على عكس ما كان يتوقع أولئك الذي راهنوا على مواجهة سياسية ودبلوماسيه بين الرياض وأنقرة.
ولعل في الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين قبل وبعد خطاب أردوغان، ما يؤكد أنَّ الرياض نجحت في إيجاد قواسم مشتركة مع الموقف التركي. ونجحت هذه القواسم، بإزالة الغمامة في علاقات البلدين، بل وفتح آفاق جديدة لها. وقد ظهر ذلك جَليًّا في كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض.
ترميم العلاقة بين السعودية وتركيا هو الخطوة الأساسية في احتواء الآثار السلبية التي تعرَّضت لها علاقات الرياض مع بعض الدول الغربية. فهذه الدول مهما كانت مبرراتها ودوافعها لتحميل الرياض المسؤولية عن جريمة اغتيال خاشقجي، لن تتجاوز بحال موقف تركيا الدولة الأساسية المعنية بهذه القضية، فأنقرة هي مَن تمسك بجوانب كثيرة من ملف القضية المثقل بالتفاصيل الجانبية، والمغطى بالكثير من المواقف والأغراض السياسية.
إعلان الرياض العمل مع تركيا لمعالجة قضية خاشقجي وكل التداعيات المتصلة بها، هو بداية الخروج من نفق الأزمة، التي أرادها البعض عاصفة سياسية مدمرة، قبل أن تتحول بشجاعة الاعتراف، وحكمة التصرف، إلى سحابة صيف عابرة